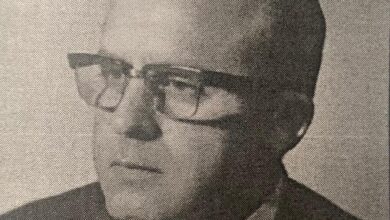فتنة العام 1860، هي فتنة طائفية عنيفة حدثت في 9 تموز عام 1860 في دمشق، كان نتيجتها مقتل خمسة آلاف مسيحي، عرفت شعبياً باسم طوشة النصارى أو طوشة الستين.
فتنة العام 1860، هي فتنة طائفية عنيفة حدثت في 9 تموز عام 1860 في دمشق، كان نتيجتها مقتل خمسة آلاف مسيحي، عرفت شعبياً باسم طوشة النصارى أو طوشة الستين.
الشرارة
في 9 تموز عام 1860، دخل مجموعة من الفتيان أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشر حي باب توما الدمشقي وبعض حارات حي القيمرية ذات الأغلبية المسيحية، وبدأوا يستفزون أهالي الحي بالكلام البذيء ورسم الصليب بالدهان الأحمر على الأرض أوعلى أبواب البيوت. شكل أهالي الحي وفداً مؤلفاً من مترجم البطريرك حنا فريج وأنطون الشامي ومتري شلهوب واشتكوهم إلى الوالي العثماني الذي قام باعتقالهم وإجبارهم على تكنيس الطرقات.
الوقائع
تكرر المشهد في اليومين التاليين مما أثار أهالي الفتيان الذين بدأوا بالصراخ بعبارات طائفية مثل “يا مسلمون يا أمة محمد، المسلمون يكنسون حارة النصارى” و”يا غيرة الدين”، مما أدى إلى تدهور الأوضاع بشكل متسارع، وهجم أهالي الأحياء المجاورة بالمسدسات الحربية والسيوف والفؤوس على الحي المسيحي، مما زاد من حدة الفتنة أن رجلاً صاح “يا ويلكم يا أهالي القنوات، مازلتم جالسين لا تتحركوا؟ ولقد قتل أكثرمن أربعين نفراً من المسلمين” والحقيقة أن اثنين فقط من المسلمين قتلا بالفعل على يد الضابط العثماني صالح زكي بك وذلك بهدف منعهما من الدخول إلى الحي المسيحي، ولكن تهويل رقم القتلى كان كافياً لتأجيج مشاعر المسلمين أكثر، الذين فعلوا كل عمل شنيع وقبيح على مدار سبعة أيام بلياليها، انسحبت خلالها الحامية العثمانية من الموقع بأمر من الوالي العثماني مع ارتفاع عدد الرعاع والمجرمين.
يلخص المؤرخ الحادثة محمد كرد علي في قوله “وخلاصتها قيام رعاع المسلمين والدروز على نصارى دمشق وقتلهم ونهبهم وإلقاء النار خمسة أيام في حيِّهم حتى خرب كلُّه، جرى هذا في مدينة التسامح واللطف. فسوَّد الأشقياء سمعة دمشق، بعد أن عاش المواطنون قرونًا في صفاء وولاء. وخسرت دمشق ألوفًا من البيوت المسيحية هاجرت إلى بيروت وقبرص ومصر واستوطنوها استيطانًا قطعيًا”، ويؤكد محمد كرد علي التواطؤ السياسي للفتنة، يكاد المؤرخون يجمعون على أن الدولة هي التي دفعت الرعاع أو غضت الطرف عنهم فارتكبوا ما ارتكبوا.
فتحت أسر مسلمة كثيرة أبوابها للمسيحيين مثل المهايني والموصلي والعمادي والنوري والعابد والأمير عبد القادر الجزائري الذي وصف دوره في هذه المحنة ابكاريوس ابراهيم بقوله “لما رأى تلك الأهوال وما وقع في المدينة من الاختلال والبوار والنكال أخذته الشفقة والحمية ودعته شيمته الأبية إلى إغاثة الطائفة النصرانية وتخليصها من هذه البلية فسارع مبادراً إلى الأسواق وفرق أبطاله في كل شارع وزقاق وخاض في جمهور المردة وأطفأ تلك النار المتقدة وخلص عدداً كثيراً من الرجال والصبيان والبنات والنسوان ودفع عنهم سيوف البغي والعدوان وأبدلهم خوفهم بأمان وأحضرهم إلى داره العامرة وكان يقدم لهم الأطعمة الفاخرة ويصرف عليهم المصاريف الجزيلة”
وصلت أعمال الفوضى إلى ريف دمشق، حيث دمرت ثلاثة بيوت مسيحية في وادي بردى، وأُحرقت كنيسة واحدة، وقُتل خمسة مسيحيين في بلودان وحُرق ٥٢ منزلاً. وفي معربا نُهِب ما لا يقلّ عن ٣٠٠ منزل، وهرب أهلها إلى دير صيدنايا. كما هرب مسيحيو صحنايا إلى قرية داريا في الغوطة الغربية حيث أعطاهم شيوخها الأمان.
كتب سايرس غراهام واصفاً المشهد الرهيب ” في هذا المساء ٢٦ تموز ١٨٦٠ مررت بالحي المسيحي، وجلت على منازله التي كنت قد زرتها منذ أسابيع قليلة فقط، عندما كانت مفخرة العرض بين قصور دمشق، فلم أجد إلا بقايا منازل، وفي معظم الأحيان، مجرد جدران بارتفاع خمس أو ست أقدام فقط. الجثث كانت تملأ المكان، تخرج منها رائحة كريهة، فلم يستطع الناس دفنها بعد، وكثيراً منها قد ألقي في الأبيار. وجدت رؤوس منفصلة عن أجسادها، وقدم هنا وذراع هناك. اثنان من المنازل كانا ما يزالان مشتعلین، تأكل النيران ما تبقى منهما. باختصار، لقد تم حرق الحي المسيحي بأكمله ولم يسلم منزلٌ واحدٌ”
النتيجة
نتج عن هذه المجزرة القضاء على خمسة آلاف من أصل اثنان وعشرون ألف مسيحي كانوا يقطنون أسوار المدينة القديمة، بين قاطن أصيل أو وافد من قرى البقاع بعد مقتلة الدروز والموارنة التي حدثت في جبل لبنان. كما رافقتها أعمال اغتصاب ونهب وحرق وهدم للبيوت والأرزاق والمصانع والكنائس والبعثات التبشيرية حتى أنهم هدموا مصلى حنانيا الشهير وحرقوا القنصليتان الروسية والأميركية.
أسباب النزاع
المناخ المشتعل طائفياً للمنطقة في تلك الحقبة
سبق الطوشة مجموعة من الأحداث الطائفية عمت المنطقة عموماً، فمن حادثة “فرية الدم” التي قُتل فيها راهب مسيحي وخادمه بظروف غامضة في دمشق عام 1840 وأُلصقت الحادثة باليهود حيث قالوا أنهم فعلوها بسبب الفطير الذي يأكلونه في عيد الفصح. إلى حادثة “قومة حلب” التي ارتكب فيها مذبحة ضد المسيحيين هناك أيضاً. كما سبق الطوشة بعام واحد مقتلة الدروز والموارنة التي اشتعلت في جبل لبنان، ووصلت الفتنة إلى مدينة زحلة، حيث فتك الدروز بأهلها المسيحيين في حزيران 1860، واحتفل بعض المسلمين في دمشق بما سموه “فتح زحلة” وزينوا حاراتهم وبيوتهم، فتسبب ذلك بإثارة مشاعر الغضب والحقد لدى المسيحيين.
السبب الاقتصادي
كانت دمشق المدينة الأهم في المشرق في مجال الصناعة الحريرية، بل كانت هذه الصناعة العمود الفقري للاقتصاد السوري حينها خاصةً بعد المرض الذي فتّك بدودة القزّ في فرنسا والصين فباتت الشام قبلة العالم لشراء الحرير. حتى أنه أطلق على حي القيمرية اسم الهند الصغرى.
تفوق التجار المسيحيين واليهود على نظرائهم المسلمين بهذه الصناعة بحكم صلاتهم بالغرب واستحواذهم على الوكالات التجارية، وكذلك حصولهم على حماية من القناصل الأجنبية، فانخفض عدد الأنوال للتجار المسلمين من أربعة آلاف نهاية الثلاثينيات إلى 853 نولاً عام 1860، فسبب ذلك استياء التجار المسلمين. وقيل أيضاً أن لفرنسا يد في اختلاق هذه الفتنة لحرق معامل الحرير في حي القيمرية.
إضافةً إلى تجارة وصناعة الحرير عمل التجار المسيحيون واليهود، مقام البنوك التجارية، التي لم تكن موجودة من حيث الإقراض وفتح اعتمادات الاستيراد وتحصيل الأموال من الخارج، مما زاد الاحساس بالغيرة والغبن لدى تجار المسلمين خاصة أن معظمهم أصبح مديون لهم، حتى أن الأمر قد وصل أن تستدين السلطنة العثمانية منهم. فشكّل هؤلاء المسيحيون طبقة ثرية أثارت حسد التجار والعامة من المسلمون.
المواطنة والحداثة
كان أول من نفخ الجمر هو محمد علي باشا، بمحاولته الجريئة لإعادة هندسة المجتمع، فكرس مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين مسلمين ومسيحين، وكانت هذه بداية ظهور الدولة المدنية في سوريا. لم ترق تلك الإصلاحات لجزء معتبر من مجتمع المسلمين الدمشقيين وقياداتهم الدينية والتجارية، وبخاصة بعد قرون من الشعور بالتفوق، فقد فرض عليهم العثمانين سابقاً لباساً خاصاً ومنعوهم من ركوب الخيل والحمير ومنعوهم أيضاً من دخول الحمامات وكانت شهادة المسلم تعادل شهادتين من المسيحيين ثم لا ننسى الجزية التي فرضت عليهم. ومما زاد من حدة الاحتقان، تنصيب عدد من المسيحيين في المجالس الاستشارية والتنفيذية مثل حنا البحري.
هذا الاستياء لم يكن بين أوساط العامة فقط، بل لم ترق هذه التغيرات للوالي العثماني في دمشق أيضاً، فطالب المسيحيين بضريبة بدل الخدمة العسكرية، فرفض المسيحيين دفعها لإرتفاعها. فوظف رجال الدين مطالباً مشايخ الشام بفتوى تقول أن المسيحي لايخدم في الجندية لأنه ذميّ وإذا امتنع عن دفع البدل يعد هذا تمرداً ويقتل.
رد فعل السلطنة العثمانية
أما عن الاجراءات المتأخرة التي اتخذتها السلطنة العثمانية فقد تمثلت بارسال السلطان العثماني عبد المجيد وزير خارجيته فؤاد بعد المجزرة بأسبوع، ورافقه جيش مؤلف من ثلاثة آلاف جندي لاستعادة الأمن والأمان، كما أمر بتشكيل لجنة تحقيق قسمت فيها التهم إلى ثلاثة أقسام “سالب ومهيج وقاتل” ورأى الوزير فؤاد باشا أن المسلمين والمسيحيين مسؤولون عما حصل.
بعدها بدأت عملية جمع المسروقات وجرى إفراغ معظم بيوت حي القنوات الدمشقي بالقوة وإعطاؤها للمسيحيين وإعادة المسروقات لأصحابها. كما أعدم بضع مئات من المشاركين في الساحات أمام الناس وسجن آخرون، كما نُفي جمع من المشايخ والوجهاء، ومنهم عبد الله الحلبي واشتدت حملات التجنيد لأهالي دمشق في الجيش العثماني.
وتدخلت فرنسا بالقضيىة فأحضرت جيشاً جراراً لدخول دمشق، وشكلت لجنة دولية للتحقيق، ولقطع الطريق على التدخل الدولي، أصدرت السلطنة العثمانية أحكام بإعدام والي الشام العثماني أحمد عزت باشا ومعه قائد حامية حاصبيا عثمان بك وقائد حامية راشيا محمد علي بك والقائد العسكري لمنطقة باب توما علي بك، ودفنوا في دمشق.
أقفل المحضر في أيلول عام 1860 ونزح آلاف المسيحيين الدمشقيين إلى بيروت والأراضي المصرية الواقعة تحت حكم محمد علي، وبخاصة من الصناعيين والتجار. وانهار الاقتصاد السوري بعدها وخرجت إلى النور طبقة جديدة من الأعيان والوجهاء والسياسيين، بعد التخلص من الطبقة القديمة.
قائمة الشهداء بقيت مجهولة، فلا نعرف عددهم بالتحديد أو هوية الكثير منهم أو حتى مكان دفنهم، إلا أن أشهرهم:
- المبشر وليام هنري، وهو ايرلندي الجنسية.
- القس يوسف حداد، راعي الكنيسة المريمة وواعظها، والمسؤول عن المدرسة البطريركية المعروفة بالآسية.
- التاجر فرانسيس مسابكي، صاحب متجر حرير في خان التتن.